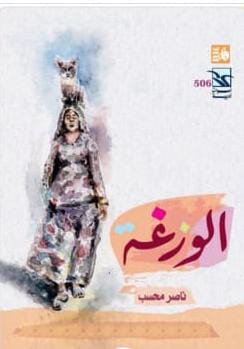
قراءة في رواية الوزغة للأديب ناصر محسب
بقلم الكاتبة و الناقدة / هالة أحمد الزقم

في إطار بيئة منغلقة شديدة الخصوصية يتنقل فيها الراوي بين الماضي والحاضر، يرسم” ناصر محسب” ملامح روايته “الوزغة” التي لا يتبلور في حبكتها صراع محوري تقليدي، بل تتعدد الصراعات وتتشابك العلاقات لترسم صورة بانورامية لحياة المجتمع الصحراوي في واحات مصر المنسية.
تتناول الرواية طبيعة الحياة في هذا المجتمع من خلال سرد يقوم على البناء ثم الهدم، فتبدأ أولى كلمات الرواية بوصف شاعري لمجمتع مترابط حميمي: “وفي خوف التصقت بيوت البلدة ببعضها وتشابكت، حتى حين شق هواجسها هذا الدرب الطويل المتعرج سرعان ما مدت السقائف أذرعها وتشابكت وضمت جانبيه، فلم تستطع أشعة الشمس أن تفض ظلالها الراكدة” انتهى الاقتباس. ثم سار السرد تدريجيًا في اتجاه هدم هذا الترابط باستعراض جوانب من نواقص هذا المجتمع، وأبرزها الطبقية الشديدة التى جعلت والد “خلف عزاز” سليل الحسب يرفض ارتباط ولده بنفيسة رزق ابنة ضارب الطوب الفقير، رغم أن حوائطه التي شيدها للبلده تشهد بحسن خلقه وأمانته! ولكن هذا لا يكفي كما يقول الكاتب:” لكن هذه الحسنات ما كانت لتشفع له أو تثقل موازينه في حال كانت الكفة المقابلة للميزان تحمل الفقر والعمل المتواضع” انتهى الاقتباس. ولم يكن خلف عزاز وحده الذي الذي ينظر لوالد نفيسة بهذه الدونية، فقد استنكر المجتمع بأكمله مجالسته ورفض حضوره لأفراحهم، فقد كان يحمل أفضالهم العضوية ولا يحملون له أفضالًا! وإن كان هذا حدث في الماضى فالحاضر كان استمرارًا لطبقية الماضى، فقد رفض مشايخ البلدة تعيين كمال العبيط زبالًا بأجر رغم أنه يقوم بالمهمة متطوعًا. ثم يعود السارد ليفاجىء القاريء بإظهار لمحات تضامن لهذا المجتمع حتى مع المنبوذين المهمشين! فيروي قصة تحمّل نفقات جنازة والد نفيسة رزق ووالدتها من قبل مجهولين لم يعلمهم أحد، ويذكر زيارة نفيسة رزق لأحمد فريح قبل موته رغم العداء بينهما.
وبخلاف الطبقية أظهرت الرواية ميل بعض أفراد الجتمع إلى ترويج الروايات التي تمس أخلاق أفراده، مثل رواية العلاقة المريبة التي تمت بين” مسعودة” أخت خليفة الطويل و”إبراهيم الولي”، والتي تسببت في مقتلها على يد أشقائها، وقبول الرواية في وسط الخبثاء من أبناء المجتمع.
أما فيما يخص الشخصيات فقد اتبع الكاتب في سرده نفس النهج، فبدأ بتقديم شخصية أحمد فريح على أنه شخص حاد صارم يربط حزامًا عسكريًا فوق جلبابه يتدلى من جانبه منجل مسنون كأنياب الشيطان، مكروه من نساء البلدة يقمن بالدعاء عليه أثناء مروره بحماره، فهو شخص فظ غليظ القلب قام بطعن حماره بالمنجل عندما رفض المسير معه، ثم ما يلبث أن يفكك الشخصية كاشفًا عن رقة أحمد فريح الذي يتعاطف مع كمال العبيط المنبوذ ويمنحه قدرًا كبيرًا من البلح مشيعًا إياه بنظرات الشفقة، ينفطر قلبه لغياب ولده يوسف حتى يتوفاه الله، فيحزن أهل القرية جميعًا لفقدان البلدة أحد أعمدتها.
ونفس الشيء حدث في تقديمه لشخصية نفيسة رزق التي بدأ بتقديم ملامحها الجسمانية الظاهرية كأمرأة قبيحة متجعدة، شعرها كالليف وأسنانها تبرز كجرافة الفرن، تجنبها أهل البلدة لسنين طويلة ووصموها بالوزغة وهي إحدى الزواحف السامة، وقالوا أن وجهها يقطع الخميرة من الماجور في إشارة لشؤمها، ثم هدم ذلك عندما كشف مأساة نفسية الجميلة التي سلبت خلف عزاز لبه، وألصقوا بها تهمة موته على يد السنوسين، فعاشت منبوذة مهمشة تصارع الحياة ولا تصرعها.
واتبع الكاتب نفس الأسلوب في تقديمه للروايات التاريخية والأسطورية التي تخص شخوص الواحة أو ما مر بها من أحداث، على سبيل المثال لا الحصر: بناء حقيقة غزو السنوسيين للواحات للاستيلاء على ممتلكات الأهالي، الذي دحضه فيما بعد عندما ذكر أن هناك أحداثًا سجلت تفيد أن السنوسيين لم يحتلوا واحة الداخلة، ولا نهبوا ولا اعتدوا على أحد- باستثاء خلف عزاز وصاحبه الذين ظنوا أنهم جواسيس- وإنما كان هدفهم محاربة الانجليز! ومثال آخر يتجلى في بناء قصة كُفر” إبراهيم ولي” وإفطاره في رمضان من شدة حرارة الجو التي دحضها الكاتب فيما بعد؛ ليقرر أن القصة بأكملها محض افتراء من” خليفة الطويل” قريبه بسبب نزاع على الميراث. وهذا الأسلوب الذي اتبعه الكاتب يخلق جوًا من التوتر، ويساعد في فهم تعقيدات الشخصيات، كما أنه يعيد تشكيل ما فهمه القاريء من قيم وأفكار مطروحة في النص.
وكما سبق أن ذكرنا، فالرواية حفلت بالعديد من الصراعات الطبقية والاجتماعية التي أشرنا إلى بعضها، كما تناولت الصراع النفسي الذي تمثل في صراع نفيسة رزق الداخلي بين ما يعتريها من آلام جرّاء ما حدث لها من فقدان حبيب ونبذ مجتمع، وبين محاولتها الصمود والبقاء داخله، بل والحصول على مكانة هامة بين أفراده، وتبدّى هذا في المهن التي اختارت امتهانها. كما تناولت الرواية صراعات أبناء الواحة مع الأساطير والخرافات التي تصل لأسماعهم، فيصدقها الكثيرون ويرفضها البعض. هذا فضلًا عن تمسكهم بعادات توارثوها دون أن يدركوا مدى جدواها مثل العادات التي يتبعونها عند تأخر الطفل في المشي. وكلها تمثل صراعات بين العقلانية واللاعقلانية في التفكير الجمعي.
وقد كان لتعدد الصراعات في الرواية أهمية كبرى في عكس طبيعة الحياة في مجتمع صغير تتشابك فيه المصائر والأحداث.
أما المكان ممثَلًا في أرض الواحة، فقد كان بطلًا رئيسيًّا مؤثرًا على الأحداث وعلى الشخوص، فطبيعة البيئة الصحراوية المنعزلة عن العالم من حولها التي يصف الكاتب وقتها بأنه: ” وقت متسع لا حدود له، الليل طويل والنهار أطول، الزمان ليس في عجلة من أمره” انتهى الاقتباس. هذه الطبيعة جعلتها بيئة خصبة لتصديق الأساطير- التي تقدمها الرواية كجزء أصيل من الحياة اليومية لأهل البلدة- بدلًا من البحث عن الحقائق وعن تفسيرات منطقية للأحداث، فصدقوا ما أشاعته ” يامنة رزة” التي تخاوي الجانّ عن اختطاف يوسف من قبل جنيَة، ولم يرفضوا من قبل قصة زواج أحد الصالحين من أخرى وإنجابه منها، بل اختلفوا فقط في عدد الأطفال المنجبين! وآمن معظمهم أن القطط تتحول إلى آدميين لهم دور البطولة في العديد من الأساطير.
هذه العزلة أيضًا جعلت المجتمع أكثر تمسكًا بعاداته وتقاليده وأشد مقاومة لتغييرها. كما أن طبيعة الحياة القاسية فيه من مناخ شديد التطرف تصاحبه ندرة في الموارد، ساعد في إكساب الشخصيات قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة أحداث الحياة المؤلمة، لعل أبرزها يتجلى في شخصية نفيسة رزق التي لا تنكسر.
أما عن الرمزية فقد حفلت الرواية بالعديد من الرموز، وحيث أن آخر ما تحدثنا عنه في السطور السابقة هوالمكان، فلنبدأ برمزيته، فالصحراء محل الأحداث ترمز في جوهرها إلى الغموض والتيه والمجهول الذي يتربص بالجميع. وأمّا عن الشخصيات، فشخصية نفيسة رزق تحمل رمزية وجودية، تشير إلى الفرد المهمش في المجتمع الذي قد يحتل مكان الصدارة في وقت ما، فمجتمع الواحة رغم نبذه لنفيسة لعدد من السنوات إلًا أنه عاد مجبرًا للتعامل معها لتوليد النساء وتغسيل الموتى وكشف الغيب الممثل في عادة ” الضمر” التي تجيدها نفيسة، ويعد الثوب النفيس المطرز الذي حصلت عليه في نهاية الرواية رمزًا للانتصار ولرد الاعتبار المتأخر. وأما وصف أو وصم نفيسة بالوزغة الذي يعكس النظرة السلبية تجاه المختلف أو المنبوذ، ويرمز للشؤم والشر، فهو يشير أيضًا للصمود والتكيف، فالوزعة ( البرص السام) في الطبيعة تستطيع التكيف مع الحياة في المناطق الجلبية والصحراوية والغابات المطيرة. وتستطيع خداع أعدائها من الحيونات المفترسة بوسائل مختلفة.
أما أحمد فريح وعمله في سن المناجل وغيرها من الأدوات فهو يرمز إلى الجانب العلمي في الحياة، وولده يوسف الذي تتناص قصته مع قصة سيدنا يوسف ووالده نبي الله يعقوب في القرآن الكريم، فترمز ملامحه المليحة التي يقول عنها الكاتب: ” يوسف مليح الوجه تميزت عيناه بلون رمادي، نظراته مزيجًا من الحدة والوقار، بالإضافة إلى شعر ناعم تراوح بين الشقرة والسواد، بخلاف بشرته البيضاء الناعمة” إلى إمكانية وجود الجمال في عالم قاس، ويرمز اسمه إلى البراءة والطهر، ويرمز غيابه إلى غيابهما في المجتمع وإلى غياب الأمل في المستقبل، وترْك نهاية قصته مفتوحة يرمز إلى احتمال عودتهما.
أما عن نهاية الرواية فلم تحمل نهايات حاسمة للأحداث كسرّ اختفاء يوسف، ولم تكشف أسباب بعض الصراعات التى وردت بها كأسباب العداء بين نفيسة رزق وأحمد فريح، ولكنها حملت مفاجأة جديدة تكشف عن زواج نفيسة رزق بشخص يسمى “قناوي مبروك”! وهو ما جعل الرواي يتشكك في وقائع الرواية وشخصياتها ويرفض استكمالها، وهي نهاية تشيرإلى أن الواقع مليء بالغموض والأسئلة التي لا تجد لها أجوبة قاطعة.
